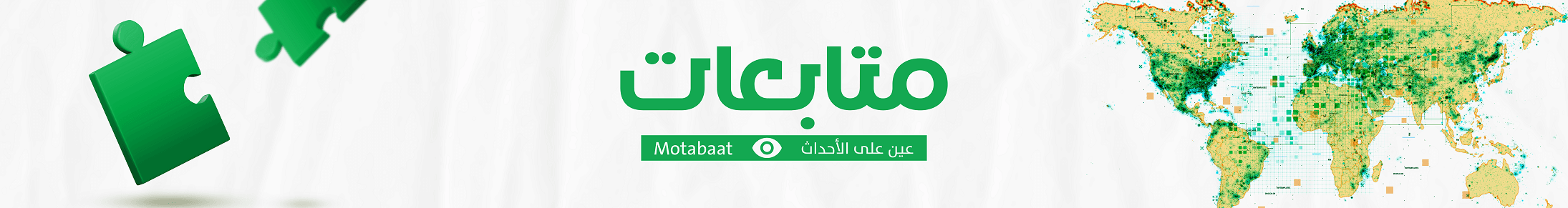السعودية تتهيّب تظاهُرات الأردن: «الطوفانُ» يتهدَّدُ آل سعود
متابعات| تقرير*:
لا تُظهر دولة شعورها بخطر ممّا يجري في الأردن من اضطرابات، بقدر السعودية التي أطلقت صحافتها وذبابها الإلكتروني للدفاع عن العرش الهاشمي. وللمفارقة، يحصل ذلك بعد سنوات قليلة من محاولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الإطاحة بالملك عبد الله الثاني وتنصيب أخيه الأمير حمزة ملكاً، والتي ما زال المتورطون فيها، ومنهم مستشار ابن سلمان، باسم عوض الله، سجناء قيد المحاكمة في الأردن حتى اليوم. في الذهاب والإياب، يتعيّن البحث عن طموح المملكة إلى التطبيع مع إسرائيل كطريقة للحصول على ضمانات أميركية لأمن النظام السعودي وسلامته: في الذهاب، حين مثّل الملك إحدى العقبات أمام تمرير «صفقة القرن» التي اعتبرها تهديداً لنظامه، وفي الإياب لكون الأردن يمثّل الآن الصلة البرّية بين المملكة والكيان، واستتباعاً عمقاً للنظام السعودي في علاقته المزمعة مع إسرائيل. «القلق» الذي عكسته وسائل الإعلام السعودية بدا كبيراً إلى درجة أزعجت حتى الأردنيين من أنصار النظام، لأن هؤلاء، وإن كانوا معنيين بإفشال ما يرونه مخطّطاً لنشر الفوضى في البلاد، إلا أنهم يدركون حساسية القضية الفلسطينية، في حين أن الإعلام السعودي بدا مندفعاً إلى تحريض الأردني ابن العشائر، على الأردني من أصل فلسطيني، في ما يمثّل وصفةً لحرب أهلية سيكون الخاسر الأول فيها هو النظام. مع ذلك، لم تصل الحالة الأردنية بعد إلى نقطة تحوّل، حيث يملك النظام إمكانات وتحالفات داخلية مع ذوي مصالح، وخارجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، قد تساعده في قمع المتظاهرين، في مقابل ضعف إمكانات من يدفعون في اتجاه توسيع التظاهرات، ليس بالضرورة لإسقاط النظام والذي لم يطالب به المحتجون، وإنما لدفعه إلى إلغاء «معاهدة وادي عربة» وإغلاق خط الإمداد البرّي عبر أراضيه إلى إسرائيل. وقد يتم قمع التظاهرات، وتنتهي الأمور هنا، ولكن ثمّة احتمال آخر يلوح ولا يمكن إسقاطه من الحساب، وهو أن يكون ما يجري مقدّمة لحدث مماثل لما حصل في «أيلول الأسود» عام 1970، والذي انتهت أحداثه بطرد «منظمة التحرير الفلسطينية» من الأردن إلى لبنان، من دون أن يعني هذا أن النظام سينجح اليوم في تكرار السيناريو نفسه.
ما يجري هو أول ترجمة عملية لتراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط كنتيجة مباشرة لعملية «طوفان الأقصى»
ما يحصل شكّل بالفعل ضربة للنظام الأردني، الذي بدا هزيلاً ومأزوماً في سعيه إلى حمايةِ مفارقةٍ من نوع أنه في حين تطْبق إسرائيل حصارها على قطاع غزة وتمنع عنه الهواء، يزوّد الأردن دولة الاحتلال بالفواكه والخضار الطازجة تعويضاً عما خسرته من مزارع «غلاف غزة»، ثم لا يتوانى الملك عن التذرّع بأن من يقوم بذلك هم تجّار أردنيون، ملمحاً إلى أن ثمة فائدة اقتصادية للأردنيين من تلك التجارة. وهو منطق أعلن المتظاهرون سلفاً رفضهم له، باعتباره إهانة، تماماً مثلما رفض الغزّيون مشاركة الملك في مهزلة إلقاء المساعدات من الجو، والتي قتلت من الفلسطينيين أكثر مما أحيت. كما أن أحد مصادر السخط الشعبي على النظام هو أنه يبيع موقفه بثمن بخس، في وقت يعاني فيه البلد أزمة اقتصادية دائمة ومستحكمة، ذات وجهين: الأول هو قلة الموارد وعدم التعويض بشكل كافٍ ممّن يستفيدون من سياسة الملك، والثاني هو الفساد الحكومي؛ وفي الحالين توجّه الأصابع إلى النظام.
وإذا كان من غير المتوقع أن تصل التظاهرات الحالية إلى إسقاط النظام الأردني، فإن المقاومة في فلسطين وأنصارها الكثر في الأردن، يمكنهم تحقيق مكاسب. ويعرف قادة «حماس» نقطة الضعف الأردنية، ولذلك خصّوا الأردنيين منذ عملية «طوفان الأقصى» بالذكر في دعواتهم للنزول إلى الشارع، من محمد ضيف إلى خالد مشعل. كما يعتقد هؤلاء وغيرهم من قادة الفصائل الفلسطينية، بما صار لهم من مصداقية، أن الظرف مؤاتٍ لتعديل الموقع السياسي للأردن عبر ضغط الشارع، سواء أسَقط النظام أم لم يسقط، الأمر الذي سيمثّل في حال حصوله أول ترجمة عملية لتراجع النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، كنتيجة مباشرة لعملية «طوفان الأقصى».
وبما أن الأردن هو البوابة الفعلية لفلسطين إلى العمق العربي، سواء في اتجاه العراق أو السعودية ودول الخليج، وصولاً إلى اليمن، فإن ما يحصل فيه له تأثير كبير خاصة على دول الخليج، وبتحديد أكبر السعودية. ما يجري اليوم، يعيد دول الخليج إلى زمن مماثل للتهديد الذي مثل أمامها في «الربيع العربي». ولذا، لن يكون مستغرباً أن تعمل الدول المذكورة على محاولة تعويم النظام الأردني عبر مساعدات سخية كتلك التي قُدّمت للنظام المصري بعد سقوط حكم «الإخوان المسلمين»، لكن هذه المرة لمنع تزايد نفوذ «حماس» في الأردن، باعتبار أن الحركة المقاوِمة، بما كسبته من شعبية وشرعية في قتالها الاحتلال في قطاع غزة، تمثل تهديداً أكبر لأنظمة الخليج، من ذلك الذي مثّله «الإخوان» وقتذاك.
* الأخبار البيروتية