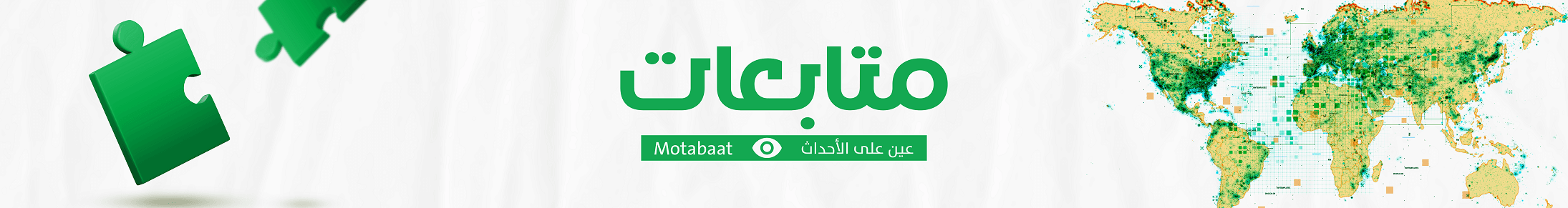(إسرائيل) تخسر ساحةَ المعركة الخالية من الدُّخان
متابعات..| تقرير:
أقرّت إدارة بايدن مشروع قانون يُجبر الشركة الصينية الأم لتيك توك، بايت دانس، على بيع حصتها في غضون عام، وإلا ستُفرض عليها حظرٌ على مستوى البلاد. ما حاولت الحكومة الأمريكية حظره قبل عام، يسعى إليه الآن حليفها الأقوى، بنيامين نتنياهو، بلهفة. وهذا ليس تخمينًا، فآلة الدعاية الإسرائيلية تتجه نحو منصاتٍ تجاهلتها سابقًا، باحثةً عن ما تبقى من نفوذٍ فقدته بالفعل.
وفي لقاء مع شخصيات مؤثرة في الولايات المتحدة في القنصلية العامة الإسرائيلية في نيويورك، ظهر نتنياهو وهو يقول:
علينا أن نقاتل بالأسلحة التي تُستخدم في ساحات المعارك التي نخوضها. وأهمها وسائل التواصل الاجتماعي. وأهم عملية شراء تجري حَـاليًّا هي تيك توك. رقم واحد. رقم واحد.
تكشف كلماته عن يأس دولة تكافح للحفاظ على تفوقها السردي؛ ما اعتبرته واشنطن تهديدًا أمنيًّا، بات الآن فرصة دعائية لكيان الاحتلال.
في مقابلة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، شرح السيناتور ميت رومني سابقًا مبرّرات حملة تيك توك الأمريكية بكل صراحة: فقد أصبحت المنصة مركزًا للأصوات الفلسطينية. وقال: “إذا نظرتم إلى المنشورات على تيك توك وعدد الفلسطينيين مقارنةً بمواقع التواصل الاجتماعي الأُخرى، فستجدون ذلك واضحًا للغاية”، مُضيفًا أن هذه الشعبيّة جعلت المنصة “موضع اهتمام حقيقي” للرئيس، الذي ستكون لديه “فرصة لاتِّخاذ إجراء في هذا الصدد”.
تكشف تعليقات الجمهوريين على تيك توك عن المنطق الكامن وراء السيطرة المُتسترة بغطاء أمني. في ندوة إلكترونية لحركة “لا للتصنيفات”، أوضح النائب مايك لولر أن احتجاجات الحرم الجامعي “هي بالضبط سبب إدراجنا لمشروع قانون تيك توك” – لأنه، كما زعم، “يتم التلاعب بالطلاب.. لإثارة الكراهية.. وخلق بيئة معادية”.
لقد أصبح القول بأن كُـلَّ مَن لا يتأثر بالدعاية الإسرائيلية مُجَـرّد “مُتلاعب به” عادة مستهلكة لدى كيان الاحتلال وحُماته وحلفائه؛ فرغم امتلاكها لوسائل إعلام تقليدية، وتعبئتها لجماعات الضغط ومراكز الأبحاث والمروجين الإلكترونيين، وهيمنتها على الصحافة السائدة، ودفعها للمؤثرين ما يصل إلى 7000 دولار أمريكي لكل منشور، وتوقيعها صفقة بقيمة 45 مليون دولار مع جوجل للترويج للدعاية الإسرائيلية بشكل جماعي وتهميش المحتوى الفلسطيني، وتشغيلها وحدة عسكرية تُسمى “خلية إضفاء الشرعية” لتبرير قتل الصحفيين، واستخدامها للقمع الخوارزمي عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وX، إلا أن آلة الدعاية الإسرائيلية قد فشلت.
وقد فشلت تحديدًا لأنها نجحت – لأنها نجحت في إظهار الوحشية للعالم، آنيًّا. نجحت في اقتلاع العائلات من منازلها، ومنع المساعدات، وتجويع المدنيين، وقتل الصحفيين والأطفال دون عقاب، وقصف المستشفيات، وتدمير الأحياء، وتجاهل وقف إطلاق النار تلو الآخر. أصبحت أول إبادة جماعية تُبث مباشرةً – يوثقها الضحايا، ويشهدها الملايين، وينكرها مرتكبوها آنيًّا. ومع ذلك، حتى بينما كان العالم يرى هذا الرعب بأم عينيه، تجرأت (إسرائيل) على تبرير أفعالها، ولعب دور الضحية، وإلقاء اللوم كله على حماس.
يكشف سعي (إسرائيل) اليائس لامتلاك كُـلّ وسيلة إعلامية تحت الشمس عن حقيقة أعمق: تسعى الحكومات، إلى جانب شركات التكنولوجيا العملاقة، إلى السيطرة على عقول المواطنين وضبطها. تعمل البنية التحتية الرقمية – الممولة بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب – على ترويض الحياة وتوحيد الآراء بما يُناسب السلطة المهيمنة. التكنولوجيا ليست محايدة. الأدوات تعكس نوايا صانعيها. يستخدمها الرأسماليون والدولة على حَــدّ سواء لتشويه الإدراك والتحكم في المعنى. تُشكل السرديات التي تُدفع عبر خوارزميات مُغلقة ما تراه الحكومات “قابلًا للعرض”. صفحة “لك” ليست لك، بل هي للامتثال.
انكشفت طموحات (إسرائيل). فبينما تندب فقدانها للرواية العالمية، لا تتورع عن أفعالها الإجرامية. فبعد أن غمرتها المليارات من التمويل الأمريكي، تُصرّ على أن هجماتها تستهدف حماس فقط – لكنها عمليًّا، صنعت مجاعة في فلسطين، تاركةً المدنيين يتضورون جوعًا وسط الأنقاض والخراب. بُني حلم ما يُسمى بالوطن على كوابيس الفلسطينيين. وقد كشف شعارها الأول – “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” – عن مخطّطها الإبادي. إن التطهير العرقي لفلسطين ليس مأساة من الماضي، بل مشروع مُستمرّ. وحتى وهي تمحو الحياة من على الخريطة، تخشى (إسرائيل) من مرآة الحقيقة التي يُظهرها الجمهور الرقمي. إنها لا تريد إسكات الفلسطينيين فحسب، بل أَيْـضًا شهود معاناتهم.
ومع ذلك، تبقى الحقيقة قائمة. فمن خلال الإعلام الشعبي، وصحافة المواطن، والمقاومة الرقمية العالمية، أشعل الفلسطينيون – رغم شحّ الموارد، وانقطاعات الكهرباء المتكرّرة، وتدمير البنية التحتية، والخسائر والمعاناة التي لا تُوصف – شعلة الحقيقة، فاشتعل ضمير العالم. رووا تجاربهم في مواجهة الإبادة، موثقةً بما تبقى منها، وفكّكوا أكاذيب السلطة المصقولة بكشف سرديات الخيانة والتحقّق من صحتها. لقد أحدثت السرديات الدقيقة للفلسطينيين، التي انتشرت بشكل طبيعي، تغييرًا كَبيرًا في نظرة الناس إلى فلسطين وحماس على نطاق عالمي.
لقد أعادت القصص التي انتشرت عبر الهواتف والأنقاض تشكيل النظرة العالمية لفلسطين وحماس، وألهبت مشاعر التعاطف والتضامن عبر الحدود. ووفقًا لمركز بيو للأبحاث، فإن 59 % من الأمريكيين يحملون الآن رأيًا سلبيًّا تجاه الحكومة الإسرائيلية، مقابل 51 % في أوائل عام 2024. وكما يشير الصحفي كريس هيدجز، “تنذر الإبادة الجماعية بنظام عالمي جديد، حَيثُ تُعتبر أُورُوبا والولايات المتحدة، إلى جانب وكيلهما (إسرائيل)، منبوذين”.
التحول واضح. من احتجاجات الشوارع والحركات الطلابية إلى اعترافات الدول والتصريحات الدبلوماسية، لم يعد العالم يصدق رواية (إسرائيل) جملةً وتفصيلًا. لا مجال للتراجع عن هذه النقطة. أي جهد تبذله (إسرائيل) لشراء وسائل إعلام جديدة، أَو لتمرير أكاذيبها عبر منصة أُخرى، هو جهد عقيم. لقد شهد الناس الحقيقة، ولا يمكنهم تجاهلها.
لطالما احتفت (إسرائيل) بتعدد أكاذيبها، واحتقرت الحقيقة الفلسطينية الوحيدة. ولم تتسامح مطلقًا مع الحقيقة – ليس من خلال الوقائع، بل من خلال العنف. ومع كُـلّ اعتداء أشد قسوة من سابقه، ترفض (إسرائيل) مشاركة أي مساحة سردية. إنها لا تسعى إلى التعايش مع الحقيقة، بل إلى إبادة من يحملونها.
لكن الباطل لا يدوم أكثر من الحقيقة. لقد أصبحت (إسرائيل) سبب دمارها في حرب العلاقات العامة. عندما يسأل الصهاينة عن كيفية تحسين صورتهم، يكون الجواب بسيطًا: كفوا عن قتل الأطفال، كفوا عن إبادة الأرواح، كفوا عن ارتكاب الإبادة الجماعية. لا يمكن لأي قدر من السرد الاستراتيجي أَو الهندسة الخوارزمية أن ينقذ دولة من الهاوية الأخلاقية التي صنعتها بنفسها.
لقد رأينا كيف يمكن للسرديات الصغيرة أن تُغيّر الوعي العالمي. الخطوة التالية هي تحويل الوعي إلى فعل – مهما كان صغيرًا. مواصلة الحديث عن فلسطين. التبرع بكل ما نستطيع. المقاطعة، والكتابة بلغة غير مستعارة من الظالم. التوقف عن التشكيك في المقاومة كما يُطالب الاحتلال، والتحول إلى مقاومة بحد ذاتها -؛ مِن أجلِ الحقيقة.
لأن الحقيقة، كما أثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا، تُفند الباطل دائمًا. ولا يمكن لأي إمبراطورية، ولا أي خوارزمية، ولا أي ميزانية دعائية أن تصمد أمام ذلك.
* عن موقع ميدل إيست مونيتور البريطانية – بتصرُّف يسير