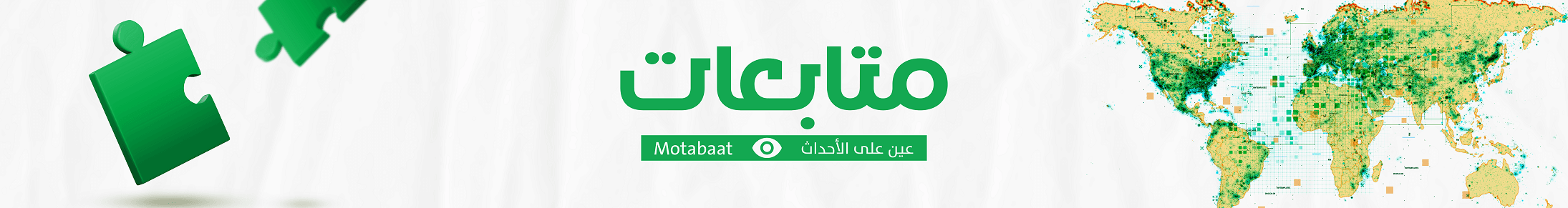فتوى “تحريم الدم” المتأخّرة: لماذا قد لا تصيب الهدف؟
متابعات..| تقرير*
في أعقاب اضطرام النار الطائفية في حمص على خلفية انتشار فيديو “مفبرك” لرجل دين درزي يسيء فيه إلى النبي محمد، وتمدّدها في اتجاه جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، خرج المفتي العام للجمهورية العربية السورية، الشيخ أسامة الرفاعي، الخميس الماضي، في شريط مصوّر حرّم فيه الدم السوري، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً في أوساط السوريين الذين سبق لبعض نخبهم وناشطيهم أن طالبوا باستصدار فتوى كهذه في أعقاب اندلاع أحداث الساحل في آذار الماضي، والتي فاق عدد ضحاياها الألفين، وفقاً لما ذكره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
والجدير ذكره أن مجموعة من الناشطين عملت على إجراء إحصاء لعدد الضحايا، والنتيجة التي خلصت إليها تؤكد أن العدد الحقيقي يفوق هذا الرقم بأضعاف. كما أصدرت هذه المجموعة لوائح اسمية لأولئك الذين قضوا في تلك المجازر، والذين بلغ تعدادهم بحسبها 17 ألفاً و361 ضحية. ومما يُذكر أيضاً أن “المرصد” يقرّ بأن أرقامه ليست نهائية، وما يورده في تقاريره يمثّل الحالات اليقينية التي استطاع الوصول إليها فحسب.
وفي ردوده المتوالية على هؤلاء، دافع خطاب المنابر المقرّبة من السلطة بأن “الشيخ الرفاعي تم تنصيبه كمفتٍ للجمهورية يوم 28 آذار”، أي بعد أحداث الساحل بـ20 يوماً، ضمن مرسوم أصدره الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، يقضي بإنشاء مجلس للإفتاء بلغ عدد أعضائه 14 عضواً، لكنّ السؤال المشروع هنا هو: ألم يكن ممكناً صدور تلك الفتوى، آنذاك، لتحمل الرقم 1 في سلسلة الفتاوى الصادرة عن المجلس الوليد؟ ولو حدث ذلك لحمل في طياته أبعاداً تختلف عما حمله توقيت صدور الفتوى، التي جاءت بعد فترة وجيزة من صدور بيان وزارة الداخلية، والذي أقرّ بـ”قصف جوي اسرائيلي استهدف بشكل مباشر قوات الأمن العام في مدينة صحنايا في ريف دمشق”، الأمر الذي دعا الكثيرين إلى الربط ما بين الحدثين، بل وحمل البعض على القول إن الثاني كان نتاجاً للأول.
فتوى الرفاعي بتحريم الدم السوري لم تصمد طويلاً
وأياً يكن الأمر، فقد نظر السوريون إلى الفتوى على أنها قد تكون أهم ما راكمته السلطة الجديدة في مسارها البادئ منذ خمسة أشهر، لكنّ العبرة لا تكون إلا بالنتائج. وبعد ساعات من صدورها، شكّك كثيرون في أنها قد لا تكون أكثر من فتوى “نظرية” قياساً إلى تركيبة المجلس الذي يرأسه الشافعي ويميل التوازن فيه لصالح السلفيين الذين يغلب عليهم فكر التطرف.
والواقع أن الفتوى لم تصمد طويلاً؛ إذ بدءاً من مساء الجمعة الفائت راح موقع “السويداء 24” يورد تقارير متتالية مفادها وجود “توتر أمني متصاعد في محيط السويداء”. ويوم السبت قال إن “فصائل محلية تتعامل مع مصادر إطلاق قذائف هاون غرب السويداء بالرشاشات الثقيلة”. وفي تقرير لاحق أفاد بأن “بلدة الثعلة استُهدفت بقذائف الهاون، وأن قرية الصورة الكبيرة جرى نهبها تماماً”، قبل أن يعلن محافظ السويداء، مصطفى بكور، أن”حكومة دمشق وافقت على رزمة المطالب التي وضعتها القيادات الروحية والمدنية في مدينة السويداء”.
والسياق الآنف الذكر لم يكن، كما يبدو، بعيداً عن سياق الفتوى، فهو أعقب قيام سلاح الجو الإسرائيلي بعدة غارات في محيط المدينة ليثبت أنه جادّ في تهديداته التي أطلقها تجاه حكومة دمشق، إذا ما فكّرت بدفع قواتها جنوباً، أو “تهديد أمن المحافظة الدرزية”.
وهكذا، يتّضح أن أصعب أنواع القرارات والمواقف، وأخطرها، تلك التي يجري اتخاذها بـ”دلالة الخارج”. ففي هذا السياق، كثيراً ما تكون المواقف، ولربما السياسات كلها، مبنية على دفع خارجي يقوم بممارسة شتى أنواع الضغوط بغية النجاح في رسم خطوط مسارات الحياة بمجملها في المجتمع المُستهدف. والمؤكد هو أن الراهن السوري يقول إن البلاد برمّتها دخلت في “متاهة” من النوع المذكور؛ فبعد خمسة أشهر، لدينا الآن ثلاث أزمات، كل واحدة منها كفيلة بتغيير “السحنة” السورية.
وعلى أي حال، لم ينجح “سهم” الفتوى، على الرغم من أنها الأقدر عملياً، في ظل هوية السلطة الراهنة وطبيعة القاعدة الداعمة لها، على إصابة الهدف. ولربما كان هناك الكثير، إضافة إلى ما سبق، مما يمكن ذكره في تبرير الفشل، ولربما كان في خلفية المشهد ما يشي بأن السوريين، شعباً وقيادة، يستعجلون يوم القيامة.
ففي ظل كل هذه الأعاصير، خرج بيان لرئاسة الجمهورية يؤكد أن “القضايا الوطنية تُعالَج عبر الآليات الوطنية وحدها، ونرفض رفضاً قاطعاً أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فسيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض”، وهذا كمن يريد القول إن الخرائط الملوّنة كفيلة بحماية الجغرافيا من خطر “السكاكين” التي راح صوت شحذها يتعالى إيذاناً ببدء تمزيق هذه الأخيرة.