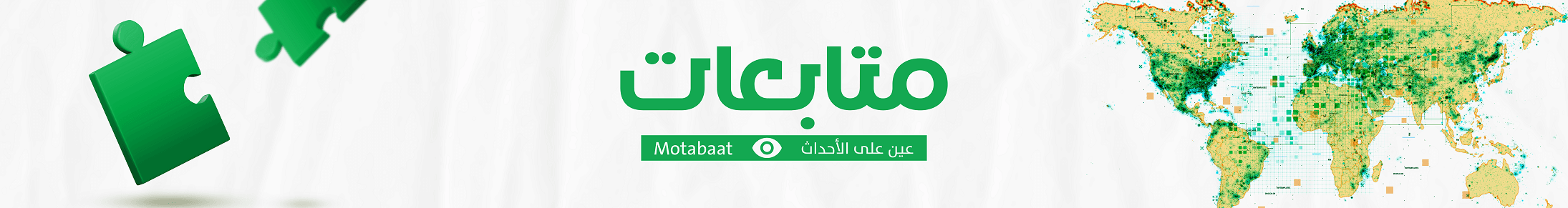«نيوزويك»: لهذا يحتاج ترامب وابن سلمان لبعضهما البعض؟
وانطلقت المجلة الأمريكية من توتر العلاقات بين الرياض وأوتاوا للتشديد على أن رسالة ابن سلمان «الشرسة» من وراء تلك الأزمة «كانت واضحة، وتستهدف جمهوراً أوسع»، في إشارة إلى إدارة ترامب التي نأت بنفسها عن الأزمة، واكتفت بدعوة الجانبين إلى العمل معاً لإيجاد مخرج للأزمة. وبحسب ما أفاد المحلل في شؤون الشرق الأوسط، بروس ريدل للمجلة، فإن مفاد الرسالة هو التالي: «إذا ما وجهتم انتقادات إلى المملكة العربية السعودية، فسوف يترتب عليكم دفع الثمن».
وأضافت «نيوزويك» أن الأزمة الكندية- السعودية «أبرزت النمط الاستعراضي (للقوة)، الذي جاء به ولي العهد محمد بن سلمان إلى سدة القيادة السعودية»، مشيرة إلى أن الرياض تخلت عن أسلوبها القديم في تنفيذ سياستها الخارجية من خلف الكواليس، بعيداً عن خوض المواجهات العسكرية المباشرة، حيث كانت تلجأ في السابق إلى دعم شخصيات سياسية حليفة لها في العالمين العربي والإسلامي، وكذلك إلى تمويل وسائل إعلام. وأكملت المجلة أن «محمد بن سلمان يعكف اليوم على استخدام الثروة الهائلة لدى المملكة، من أجل معاقبة منتقديه، وأعدائه، سواء عبر استخدام ديبلوماسيته العارية، أو عن طريق العمل في ساحات القتال»، على غرار ما يجري في اليمن.
وأردفت المجلة أن الخلاف الكندي- السعودي «كشف عن استعداد الرئيس دونالد ترامب للتخلي عن القيادة الأخلاقية لأمريكا، على صعيد الدفاع عن حقوق الإنسان»، مضيفة أن زيارة الأخير للرياض في مايو من العام 2017، ومواقفه التي أحجم فيها عن تناول الوضع الحقوقي في الداخل السعودي، كرسته كـ«أول زعيم أمريكي يعلن أن ملف حقوق الإنسان، خارج جدول أعماله الديبلوماسي»، وذلك انطلاقاً من «العلاقات الوطيدة» التي تربط صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنير، بابن سلمان، وإبقاء إدارة الأخير على دور واشنطن «الخفي» في حرب اليمن، التي دخلت عامها الرابع، إلى جانب مساندة الرياض في عدد من القضايا الخارجية، كأزمتها مع قطر، وفي عدد من السياسات الداخلية كحملة الاعتقالات التي دشنها الأمير السعودي ضد عدد من الأمراء، والدعاة، ورجال الأعمال، فضلاً عن اعتقال قرابة 2000 من النشطاء السياسيين.
وشددت «نيوزويك»، تحت عنوان: «لم يحتاج كل من دونالد ترامب وابن سلمان لبعضهما البعض… حتى في ظل تضعضع العلاقات (الأمريكية- السعودية)»، على أن «الفوائد الاستراتيجية القيمة التي توفرها المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة، والتي تشمل التعاون الاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب، والحقوق المعطاة من قبلها لطيران سلاح الجو الأمريكي من أجل التحليق فوق منطقة هامة من العالم، علاوة على كونها سوقاً رائجة للمعدات العسكرية الأمريكية، وثقلاً (إقليمياً) موازياً لإيران، كلها عناصر أسهمت في إبقائها في منأى عن العقوبات الأمريكية».
ومن هذا المنطلق، أفاد ديبلوماسيون أمريكيون سابقون للصحيفة بالقول، إنه «بالنظر إلى الإعتبارات المبينة أعلاه، فإن رفض إدارة (ترامب) دعم كندا، يعد أمراً منطقياً إلى حد كبير». وفي السياق ذاته، قال شاس فريمان، وهو سفير أمريكي سابق لدى الرياض، «إن القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، والقيم (الديمقراطية)، لم تكن يوماً في صلب العلاقة» بين السعودية، والولايات المتحدة، مشدداً على أنه «منذ البدء، لطالما كانت تلك العلاقات مدفوعة بعامل المصالح القومية لكلينا».
العلاقات الأمريكية- السعودية عبر التاريخ
هذا، وعرّجت «نيوزويك» على المحطات التاريخية الأبرز في العلاقات الأمريكية- السعودية، ولا سيما لقاء الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، والملك السعودي عبد العزيز آل سعود في العام 1945، واتفاقهما على ترسيخ مبدأ «النفط مقابل الأمن». وبحسب المجلة، فإنه، «ومنذ ذلك الحين، فقد امتنعت كل إدارة أمريكية عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن أداء المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتفضيلها التعامل مع القضية، عند الضرورة، من خلف الأبواب الموصدة»، باستثناء حالتين شهدتا قيام رؤساء أمريكيين بممارسة ضغوط على السلطات السعودية في هذا الخصوص، أولاها كانت في العام 1962 حين أقنعت إدارة الرئيس جون كينيدي الملك فيصل بضرورة وقف العمل بنظام الرق، فيما كانت الثانية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لدى تدخله من أجل تأجيل تطبيق عقوبة جلد ثانية بحق المدون السعودي رائف بدوي. وبالعودة إلى حديث ريدل للمجلة، فإن «كل رئيس أمريكي، منذ عهد فرانكلين روزفلت، عمد إلى تغليب مسألة النفط، والقضايا الاستراتيجية على حساب قضايا حقوق الإنسان في تعاملاته مع الملوك السعوديين، وذلك بداعي الخوف من حصول اضطراب على مستوى العلاقات الثنائية. غير أن ترامب، نقل هذه الحالة من تغييب المساءلة (إزاء السعودية) إلى مستوى جديد من الإهمال، والتجاهل» على هذا الصعيد.
من جهة أخرى، نقلت «نيوزويك» عن خبراء قولهم إنه «وبالرغم من العلاقات الودية بين عائلة ترامب، وآل سعود، إلا أن الإطار الأوسع للعلاقات بين الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية قد بدأ يتآكل»، موضحة أن هؤلاء الخبراء يرون أن «هذا الانحلال (في عرى العلاقات) إنما يعود إلى فك الارتباط الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط ككل، الذي بدأ خلال عهد الرئيس أوباما، وكذلك إلى تحركات ولي العهد السعودي لصياغة دور أكثر حزماً للمملكة في المنطقة».
ولتأكيد هذا الإنطباع، أوردت المجلة تصريحات للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، في يوليو الماضي، قال فيها إنه «على مدى السنوات العشر الماضية، ثار جدل في الولايات المتحدة، بأن الأخيرة لا تريد الإنخراط بشكل أكبر في الشرق الأوسط». وأضاف العتيبة أن «أحد كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين نظر إلي في إحدى المرات، وقال لي إنه لا يوجد تأييد شعبي داخل الولايات المتحدة من أجل أن نباشر القيام بفعل المزيد في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن ذلك «يعني أننا بحاجة إلى تولي شؤوننا بأنفسنا».
حرب اليمن والمصالح الأمريكية
وتابعت «نيوزويك» بالإشارة إلى أن بعض جوانب سياسات حلفائها الخليجيين باتت «تؤذي مصالح الولايات المتحدة في المنطقة»، ذلك أن «الغارات السعودية، التي تسفر من حين إلى آخر عن مقتل مدنيين أطفال في اليمن، ترتب عنها إدانات دولية، وهي إدانات تشمل اليوم توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بالتورط في تلك الأفعال، وذلك بفضل الأسلحة، وخدمات التزود بالوقود جواً، التي توفرها أمريكا إلى التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية» على الساحة اليمنية، بحسب ما أفاد فيرمان للمجلة. وأكمل أن «الحصار السعودي المفروض على قطر، حيث يقع مقر أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، هشّم وحدة دول مجلس التعاون الخليجي».
كذلك، أوضحت «نيوزويك» أن حضور عامل موارد الطاقة، في العلاقات الأمريكية- السعودية «يضعف»، حيث أن ابن سلمان «وافق في يونيو الفائت، على طلب الرئيس الأمريكي، وعمد إلى رفع إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، غير أنه، ومذاك، لم يبادر إلى رفع الإنتاج إلى مستويات أعلى، ما شكل ضربة لترامب، الذي بدوره يعتمد على (إمكانية) ضخ المزيد النفط السعودي لمنع ارتفاع أسعار النفط».
وفي ما يخض الدعم المالي السعودي لمبادرات السياسة الخارجية الأمريكية، ذكرت «نيوزويك» بقيام الرياض في ثمانينيات القرن الماضي بتمويل حرب «المجاهدين» في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي، إلى جانب مشاريع أمريكية أخرى حول العالم، لافتة إلى أن «السعوديين، في ظل ابن سلمان، أصبحوا أقل سخاء» في هذه المسألة، حيث طالبت إدارة ترامب، في مطلع العام الجاري، الرياض بتقديم مساهمة مالية بقيمة 4 مليارات دولار، من أجل تخصيصها لمشاريع إعادة إعمار مناطق واقعة في الشمال السوري، قبل أن تحصل على 100 مليون دولار من المبلغ المطلوب. وشرحت المجلة أن «المسؤولين السعوديين يزعمون أن استجابة حكومتهم (حيال تلك المطالب)، تعكس أولويتها التي تنصب على تمويل الحرب في اليمن، وتجهيز أطقمها (العسكرية) لهذا الغرض»، محذرة من أن تواضع المساهمة المالية السعودية «ربما تكون تخفي حقيقة أعمق» من الأسباب المبينة أعلاه. وعلى هذا الأساس، نبّه فريمان إلى أن «السعوديين لم يعودوا ينظرون إلينا على أننا (الحليف) المدافع عنهم، والذي يمكن الوثوق به»، مشدداً على أن «نسيج العلاقة (بين الرياض وواشنطن) قد تمزق».
الكونغرس وصفقات الأسلحة
كما ذهبت «نيوزويك» إلى أن عقلية القادة السعوديين الجدد «أوصلت نزيف (العلاقات الثنائية) إلى مستوى الروابط التجارية»، بخاصة على صعيد شراء الأسلحة الأمريكية، عازية الأمر إلى «المعارضة المتنامية» في أوساط الكونغرس لبيع صفقات الأسلحة إلى الرياض، وتوجه المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى «تنويع مصادرها التسليحية»، لتشمل كل من الصين، وروسيا، وبريطانيا، وتركيا، وفنلندا، ودول أخرى.
ونقلت المجلة عن مصدر ديبلوماسي عربي قوله إن «محمد بن سلمان شعر بالدهشة في بادئ الأمر، حين زعم ترامب علانية أن الرياض وافقت في العام الفائت على شراء أسلحة بقيمة 110 مليار دولار، فيما لم يتم التوقيع على أي صفقات مماثلة في واقع الأمر». وتابع المصدر الديبلوماسي العربي حديثه إلى المجلة، بقوله إن ولي العهد السعودي «انزعج لدى قيام ترامب بتكثيف الضغوط عليه من خلال عرض صور» لمعدات عسكرية أمريكية من أجل بيعها للرياض إبان زيارة الأمير الشاب إلى البيت الأبيض.
إلى ذلك، سلطت «نيوزويك» الضوء على عامل آخر أسهم في تضعضع العلاقات بين واشنطن والرياض، مشيرة إلى أن «قدرة المملكة العربية السعودية على تسويق السياسات الأمريكية إلى باقي أنحاء العالمين العربي، والإسلامي تنكمش، وتتلاشى، وذلك يعود بشكل كبير إلى الإرث القاتل (من أخطاء تلك السياسات) في كل من العراق، وأفغانستان، ومواصلة العمليات العسكرية الأمريكية في إطار مكافحة الإرهاب في 76 بلداً». وعلى هذا الصعيد، صرّح السفير فريمان للمجلة بأنه «كان هناك وقت مضى، كانت المملكة العربية السعودية، وفي ضوء ما تحظى به من شرعية كدولة معنية بشؤون الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، تقدر فيه على التصرف كطرف مدافع عن الولايات المتحدة في العالم الإسلامي»، في إشارة إلى عدم قدرة الرياض على تمرير «اتفاق سلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعده جاريد كوشنير، وهو اتفاق أبدى ابن سلمان في الكواليس موافقته عليه.
(العربي)