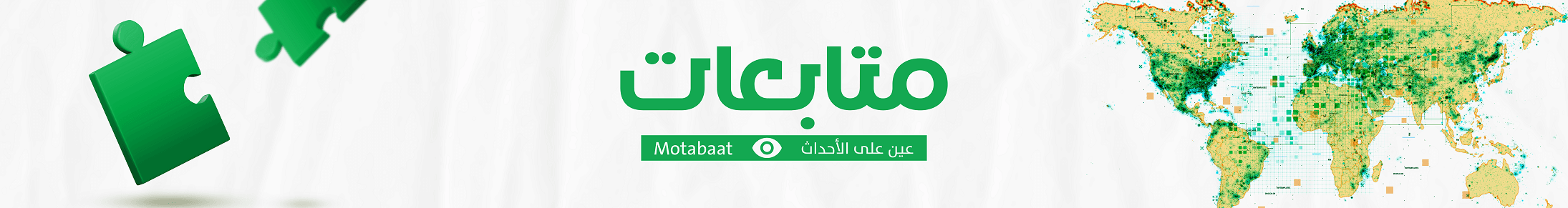السعودية لا تحتمل التصعيد وترامب لن يجازف بحمايتها
السعودية لا تحتمل التصعيد وترامب لن يجازف بحمايتها
متابعات:
نشر مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مؤخراً، مقالة افتتاحية في صحيفة “نيويورك تايمز” يدعو فيها إلى إنهاء حرب اليمن فعلياً قبل أن تتوسع وتصبح حريقاً إقليمياً خارجياً. مع ذلك، كانت الخطوط العريضة التي قدمها طموحة للغاية، وقدم فيها نصيحة عملية بسيطة حول ما يجب إنجازه بالضبط. تحتاج السعودية إلى أن تتخلى عن الأذرع اليمنية القديمة وتعيد تأسيس نفوذها مع قبائل شمال اليمن. لكن قبل أن تفعل ذلك، ستحتاج إلى أن تعترف أولاً بفشل تدخلها الكارثي؛ وهو اعتراف صعب في وقت يتم فيه لعب دور القومية من قبل النظام السعودي.
عندما قرر محمد بن سلمان، وزير الدفاع آنذاك، ذو الـ31 عاماً، التدخل في اليمن، كانت توقعاته أن يتم الاستيلاء على صنعاء في بضعة أشهر. وبعد كل شيء، كانت السعودية ضمن 5 بلدان تتصدر القمة عالمياً في الإنفاق العسكري وفي امتلاك كل لوازم الجيش العظيم. لكن هذا الأمر لم يكن يعني سوى امتلاك مهارة عسكرية عالية. أو هكذا ذهبت القصة في هذا المعنى. فالجمع بين انعدام التخطيط وانعدام الخبرة القتالية، والتهرب من التضحية بالدم السعودي لتقليل معارضة الحرب كان يعني دعوة واستجلاب قوات أجنبية من أجل المساندة. ولكن حتى مع مساعدة الإماراتيين، والأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والسودانيين والأردنيين والمغربيين وآخرين لا يمكن حصرهم، بقي الحوثيون ثابتين في صنعاء. وقد دفعت حملات القصف الجوية الوحشية والحصار الاقتصادي بالأمم المتحدة أن تدعو إلى وقف الاقتتال والعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن عندما كانت السعودية تدفع بأجندة محلية وكانت تسعى إلى إظهار قوة جيشها، كانت ستعتبر الدبلوماسية علامة ضعف، وقد تم تجاهل تلك الدعوات.
في مارس 2018، عندما أطلق الحوثيون في وقت متزامن عدداً من الصواريخ على السعودية، كنت في تلك الأثناء أنصح الحكومة بإنشاء وحدة وطنية تهتم بالمخاطر وتحديد وتقييم وتخفيف مجموعة من التهديدات الخارجية في الوقت الحالي وفي المستقبل بما فيها المخاطر الطبيعية والحوادث التي من صنع البشر والأعمال الضارة. ولحسن تقديرها، كانت الوزارة التي تقود هذه المبادرة نيابة عن الحكومة الملكية متقبلة للاقتراحات التي طرحت، واعترفت بضرورة تفعيل هذه الوحدة في أسرع وقت ممكن. وكنتيجة، بدعم من بعض الموظفين المدنيين السعوديين المتألقين والمجدين، وبمباركة المكتب الوزاري، بادرنا بمشاركتنا مع أصحاب التهديدات المحلية الذين حددناهم.
ولكن عندما بدأت الصواريخ الحوثية تتوالى بشكل أكثر انتظاماً من السابق، لم تكن السلطات قلقة بشأنها على الإطلاق؛ بالنظر إلى فاعلية الأنظمة الدفاعية الجوية الجلية للمملكة في اعتراضها قبل وصولها. ولم تفزع ذيول دخان الصواريخ الحوثية المرسومة في سماء الرياض أي شخص، وكان السكان يهتفون أثناء توثيقهم لاعتراض الصواريخ قبل أن يقوموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى أن اتضح أن القلق المباشر أكبر من تفشي وباء أنفلونزا الطيور التي انتشرت في جميع أنحاء البلد، الأمر الذي أدى إلى نفوق شامل للدواجن والطيور، وهو قلق حقيقي بلا شك نظراً لأسعار المواد الغذائية والمخاطر الاجتماعية التي يمكن أن يمثلها هذا. ومع ذلك، تم رفض الاقتراحات للأخذ بعين الاعتبار تهديد الصواريخ بجدية أكثر. ومن خلال العلاقات الأكاديمية في أوروبا، اقترحت بسذاجة إمكانية بدء حوار غير مباشر مع القيادة الحوثية، على افتراض أن قنوات الاتصال الخلفية لم تكن موجودة بالفعل.
وليس فقط تم تجاهل الاقتراح، بل وأدى أيضاً إلى تساؤلات حول دوافعي ومصالحي، حيث إن حل خطر قومي من خلال حوار كان أمراً مبغوضاً. بالنظر إلى الثقة بأن القوة العسكرية وحدها، يمكن أن تكون كافية لسحق جيش من المتمردين الذين يقاتلون بالـ”إي كي 47″. في الأشهر اللاحقة، تابعت الصواريخ اختراق المجال الجوي السعودي، وتلتها ضربات الدرون القاتلة التي أحدثت دماراً في محافظات جيزان ونجران وأبها القريبة من الحدود اليمنية. وعندها بدأت تصل إلى منشآت النفط في الشمال. ولعل آخر ضربة كانت في منشأة النفط في البقيق في أوائل هذا الشهر.
لم تعد السعودية تحتمل استمرار هذا التصعيد. على الرغم من كل دعمه العلني، فإن دونالد ترامب لا يحتمل أن يجازف بإشعال حريق إقليمي، ولا تستطيع السعودية تحمل ضربة خلفية تأتيها من إيران في حال أثبتت في النهاية أن الهجوم جاء من الأراضي الإيرانية. وبما أن قوة إيران والحوثيين قد تعززت بنجاحهم، سيزاد الوضع سوءاً فحسب. للخروج من هذه الدوامة، ينبغي أن يكون تركيز السعودية على التعاقد المباشر مع الحوثيين وأن تعيد إنشاء نفوذها في معاقلهم في اليمن؛ وهو نفوذ كانت تملكه بيد أنها فقدته تدريجياً عقب التوقيع على اتفاقية جدة في 2000 التي رسَّمت الحدود بين كلا البلدين.
كان التدخل السعودي في اليمن سابقاً للثورة اليمنية في 1962، عندما دعمت الملكيين الذين يقودهم الإمام الزيدي ضد القوات الجمهورية التي تدعمها مصر. وكما قال الملك السعودي السابق عبدالله بن عبد العزيز في 2007، إن أمن اليمن “غير منفصل” عن أمن السعودية، الأمر الذي برر بشكل غير مباشر ما يصنفه آخرون بأنه تدخل في الشؤون الخارجية، دعمت السعودية قادة قبليين وأكاديميين وضباطاً عسكريين وسياسيين برواتب شهرية كبيرة، وهو الأمر الذي سمح بضمان مصالحها الأمنية. كان الشيخ عبدالله الأحمر زعيم مجموعة قبائل حاشد (الأكثر قوة وشعبية في شمال اليمن) ورئيس البرلمان اليمني ما بين العام 1993 وحتى موته في 2007، يُدفع له ملايين الريالات السعودية في كل شهر. في الرياض، كانت “هيئة خاصة” مكرسة لشؤون اليمن تراقب وتدير التطورات السياسية في البلد، في الوقت الذي ضمنت فيه أيضاً التدخل في الشؤون الخارجية لمصر وإيران.
ومع وصول العقد الأول من الألفية إلى نهايته، أدى تطوران هامان بالسعودية إلى فقدان قبضتها على شمال اليمن. ففي 2005، أصيب الأمير سلطان بن عبد العزيز-الذي قاد الهيئة الخاصة لأكثر من عقد- بالمرض وتدهورت صحته العقلية مما دفعه إلى البحث عن علاج في الولايات المتحدة. وفقد التركيز على اليمن، وبدأ تمويل القبائل يجف. ظهر هذا جلياً في عام 2007 عندما مات عبد الله الأحمر تاركاً خلفه عشرة أولاد قوض جدلهم السياسي تماسك الاتحاد، مما صعب الأمر أكثر على السعودية في تأمين مصالحها. وعندما مات الأمير سلطان في 2011، كانت الهيئة الخاصة موجودة بالاسم فقط وكانت التغييرات المزلزلة في طريقها إلى اليمن التي ستؤدي في النهاية إلى سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء وتحكم واسع بالدولة.
على الرغم من الخسارة الكبيرة للذاكرة السعودية المؤسسية في الشؤون اليمنية وحرب الأشقاء التي مزقت قبائل اليمن والتركيب الاجتماعي، هنالك حاجة ملحة للسعودية إلى أن تعيد فرض نفوذها. وبينما من المفهوم أن شقيق محمد بن سلمان، خالد، هو الآن مكلف بالملف اليمني، إلا أنه من الملح إعادة الخبراء السعوديين البارزين الذين لعبوا دوراً فعالاً في الهيئة الخاصة. هذه الحالة تنطبق بوجه الخصوص على الدكتور مساعد العيبان الذي اكتسب خبرة لا مثيل لها في الشؤون القبلية بفضل مشاركته في تعيين الحدود السعودية اليمنية في 2000. يجب أن يشارك خبراء مثل العيبان في جهد دبلوماسي متزامن مع جهد الأمم المتحدة، حيث تتشارك السعودية بشكل مباشر مع الحوثيين بعين نحو التأسيس أو على الأقل نحو وقف جزئي لإطلاق النار.
لكي ينجح هذا، سيكون من الأساسي أن تضمن السعودية للحوثيين مكاناً في حكومة اليمن المستقبلية، وأن تلتزم بإعادة بناء البنية التحتية المدنية التي دمرتها. ستحتاج السعودية أيضاً إلى أن تقدم ضمانات بأنها لن تدعم إنشاء المدارس السلفية في قلب شمال اليمن الزيدي؛ في حين أن الجانب الحوثي سيحتاج إلى الالتزام بوقف ضرباتهم العابرة للحدود، والأهم من ذلك إنهاء علاقاتهم مع إيران والجماعات التابعة لها. بتفضيل الدبلوماسية على المواجهة، سيكون لدى السعودية فرصة لإثبات أنها لاعب ناضج على مسرح العالم، وفي الوقت ذاته تقوض حجج منتقديها. وإذا كان التفاخر لا يزال يمنع حدوث هذا، فمن المهم حينها تذكر كلمات أتال فاجبايي: الدبلوماسية الهادئة أكثر فاعلية بكثير من المواقف العامة.
* نيكولاس دونيس – مستشار مستقل لحكومات مجلس التعاون الخليجي في مسائل التنمية الاقتصادية والأمنية
“لوب لوغ” مدونة أمريكية على النت